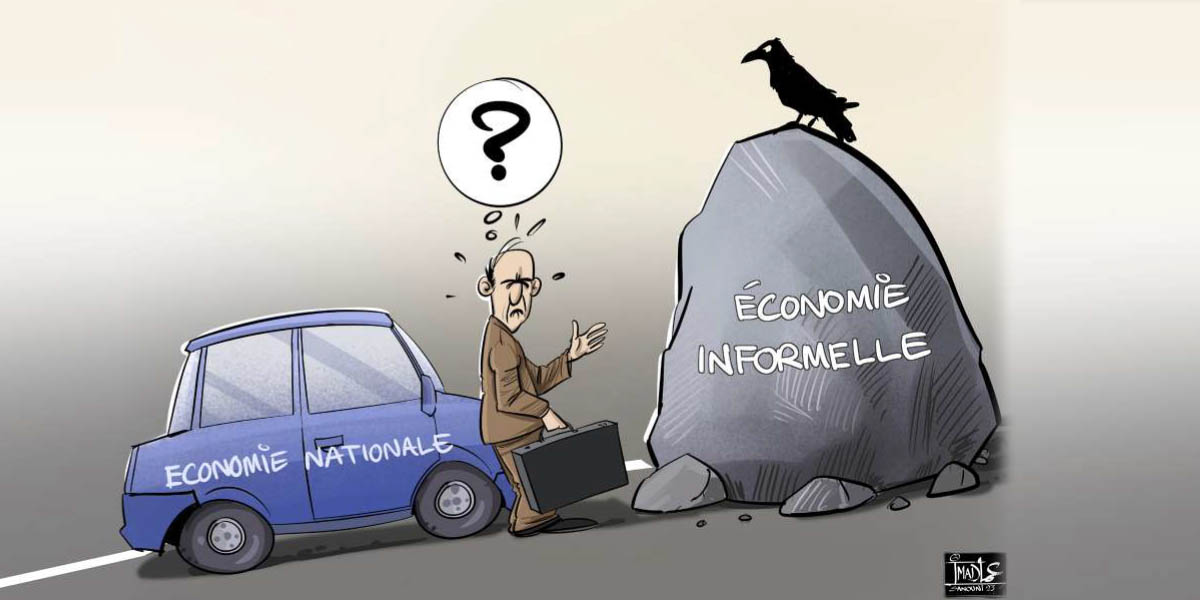ياسـين أحمــامد: مساهمة التنظيم الترابي في إصلاح الهندسة المؤسساتية للجهات

ياسـين أحمــامد دكتور في القانون العام جامعة الحسن الثاني. كلية الحقوق بالمحمدية
الملخص:
إن اتساع مجال الصلاحيات المخولة للجماعات الترابية لا سيما على المستوى الجهوي وأهمية الموارد البشرية والمالية التي وضعت رهن إشارتها، تتطلب النهوض باللاتمركز الإداري ووضع رؤية جديدة لتدخل الإدارات اللاممركزة للدولة، تحت إشراف والي الجهة، على المستوى الترابي.
وتماشيا والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تعرفها المملكة، شهد التنظيم اللامركزي تطورا نوعيا على قدر كبير من الأهمية تمثل في صدور القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
ولأجل ذلك، أصبح ضروريا مراجعة المقتضيات الحالية المعمول بها في مجال اللاتمركز الإداري والانخراط في إعداد منهجية واضحة لكافة القطاعات الوزارية لتنفيذ لاتمركز حقيقي قوامه الفعالية والنجاعة، ويسمح بتحقيق التغيير المنشود في إطار سياسة إرادية شمولية ومنسجمة، وهو الأمر الذي عجل بإصدار ميثاق بمثابة خارطة طريق للاتمركز الإداري.
الكلمات المفاتيح : الجهات ، التنمية الترابية ، اللاتمركز الإداري، الدستور، القانون التنظيمي111.14، الجماعات الترابية، الحكامة، الهندسة المؤسساتية.
Summary:
In keeping with the social, economic and legal transformations in the Kingdom, the decentralized organization witnessed a qualitative development of great importance, represented by the issuance of Organizational Law No. 111.14 related to entities, and Organizational Law No. 112.14 related to employment and regions, and Organizational Law No. 113.14 related to groups.
Undoubtedly, the expansion of the powers vested in the territorial groups, especially at the regional level, and the importance of the human and financial resources that have been placed under their control, require the advancement of administrative decentralization and the development of a new vision for the intervention of the decentralized administrations of the state, under the supervision of the governor of the region, at the territorial level.
To achieve this goal, it became necessary to review the current requirements in force in the field of administrative decentralization and to engage in the preparation of a clear methodology for all ministerial sectors to implement a true decentralization based on effectiveness and efficiency, and that allows the desired change to be achieved within the framework of a comprehensive and coherent voluntary policy, which hastened the issuance of a charter as a roadmap Administrative center.
Key Words: advanced regionalization, territorial development, the pact of administrative decentralization, the constitution, organizational law 111.14, territorial communities, governance.
مقــــدمــــة:
تم إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري تفعيلا للتوجهات الملكية السامية الموجهة للحكومة وذلك من أجل مواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتوفير الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية للدولة على الصعيد الترابي، إضافة إلى الدور المحوري لوالي الجهة باعتباره ممثلا للسلطة المركزية في الجهة وذلك بسهره على تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها ومراقبتها تحت سلطة الوزراء المعنيين. إضافة إلى الاعتماد على عدة مرجعيات رئيسية والتي تم الاستناد إليها من أجل المساهمة في إعداد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
ويهدف ميثاق اللاتمركز الإداري إلى دعم الديمقراطية المحلية وتطوير الخدمات الإدارية وملاءمتها والاتتظارات المحلية، إلى جانب فعالية الإدارة اللاممركزة، هذا وتهتم محاور إصلاح الإدارة اللاممركزة إلى إبراز صدارة المستوى الجهوي في تمثيل الإدارة المركزية وإعداد السياسات العمومية، و تحديد المبادئ وتوجهات اللاتمركز الإداري بالإضافة إلى ترشيد وعقلنة تنظيم المصالح اللاممركزة، مع الارتقاء بالتدابير المالية اللاممركزة والتنسيق بين أنشطة المصالح الإدارية فيما بينها
وتماشيا مع المكانة المهمة التي حظي بها موضوع الجهوية المتقدمة ضمن الخطب الملكية السامية، فقد تجسد هذا التوجه بالوضوح بعد صدور دستور 2011[1]. هذا الأخير أولى موضوع الجهوية المتقدمة مكانة مهمة عندما خصص بابا كاملا للجماعات الترابية، وفي مقدمتها الجهة التي منحها المشرع اختصاصات واسعة ومهمة، عكست بجلاء نية المملكة نحو تعزيز مكانة اللامركزية، كتنظيم ترابي دستوري للمغرب[2].
وتتضح أهمية هذا الموضوع بجلاء في كون الجهوية التي يسعى المغرب جاهدا بلوغها بشتى الوسائل الديمقراطية، تشكل الأداة الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإطار الفعال لتجسيد مبادئ الحكامة التي نص عليها دستور المملكة، من مشاركة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهذا ما جعل الأنظمة المعاصرة تجعل من الجهوية مكونا رئيسيا ضمن تنظيمها الإداري.
ولطالما ارتبطت السياسة الجهوية في المغرب بعامل التنمية الترابية، ذلك أنه وتفاديا لبروز مناطق مزدهرة جدا ومنتجة مقابل مناطق مهمشة، برزت الحاجة إلى تطوير الجهوية من خلال مجالات حيوية كالتنمية الاقتصادية، والتخطيط والاستثمار الأجنبي، وذلك لن يتأتى إلا من خلال إيجاد آليات قانونية ومؤسسات قادرة على مسايرة ركب وأهداف ورش الجهوية المتقدمة، ومن هنا برزت فكرة إعداد ميثاق اللاتمركز الإداري كآلية للتنزيل الصحيح لورش الجهوية من جهة، ومن جهة أخرى ظهور مؤسسات المراكز الجهوية للاستثمار من خلال تاطيرها هي الأخرى بميثاق للاستثمار، على اعتبار أن النهوض بالتنمية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار في الرأسمال البشري، وتقوية التضامن بين الجماعات الترابية واعتماد الابتكار لتدبير التنوع في أوساطها، والتحكم في مستقبل النمو الحضري بها.
لذلك فالرهان على الجهوية اليوم رهان على التنمية الشاملة، وتحديث البنية المؤسساتية للدولة لما ستتيحه الجهوية من تحقيق التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي لكافة المناطق، عبروضع مخططات واستراتيجيات مختلفة وبرامج لمكافحة الاختلالات والفوارق المجالية والاجتماعية.
بيد أن إنجاح مشروع الجهوية المتقدمة بالمغرب رهين بالعمل الجاد على التنزيل السليم للمرتكزات الأساسية لهذا المشروع الوطني الطموح وفق ما جاء به الفصل 136 من دستور 2011[3]. والذي ينص صراحة أن التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يرتكز على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة. أما الفصل 137 من نفس الدستور فينص على “أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى تساهم في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين”، وهذا الفصل يوضح بشكل مختصر الأدوار الكبرى المتوخاة من الجهة باعتبارها أهم جماعة ترابية يرجى منها تحقيق التنمية الترابية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي[4].
ومن أجل الإحاطة بموضوع اللاتمركز الإداري ودوره في إنجاح التنظيم الجهوي الحالي كان لزاما علينا وضع إشكالية رئيسية للموضوع، والتي تتلخص في:
مدى إمكانية ميثاق اللاتمركز الإداري للدفع بالتنظيم الجهوية الحالي من أجل تنمية وإعادة مؤسسة الجهات ؟ وهل يوفر التنظيم الجهوي الحالي للجهات مايؤهلها من موارد مالية ولوجستيكية كي تكون أداة فعالة للتنمية الترابية ؟.
وللتطرق لموضوع اللاتمركز الإداري في علاقته بسياسة الجهوية المتقدمة، كان من الضروري أن نقسم هذا الموضوع لمحورين أساسيين:
- المحور الأول : اللاتمركز الإداري: آلية استراتيجية لتفعيل الجهوية المتقدمة.
- المحور الثاني : أسس ومبادئ الجهوية المتقدمة كما يحددها القانون التنظيمي 111.14.
المحور الأول: اللاتمركز الإداري: آلية استراتيجية لتفعيل الجهوية المتقدمة.
مواكبة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تعرفها المملكة، شهد التنظيم اللامركزي تطورا نوعيا على قدر كبير من الأهمية تمثل في صدور القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
ومما لا شك فيه، فإن اتساع مجال الصلاحيات المخولة للجماعات الترابية لا سيما على المستوى الجهوي وأهمية الموارد البشرية والمالية التي وضعت رهن إشارتها، تتطلب النهوض باللاتمركز الإداري ووضع رؤية جديدة لتدخل الإدارات اللاممركزة للدولة، تحت إشراف والي الجهة، على المستوى الترابي.
وفي هذا الإطار، انكبت الحكومة على إعداد تصور جديد للإدارة اللاممركزة يتوخى الاستجابة للأهداف التالية:
– تثمين فاعلية الإدارة اللاممركزة عبر تحسين علاقة الإدارة بالمواطنين (علاقة الإدارة – المواطنين)؛
-المساعدة وتقديم الدعم والاستشارة للمنتخبين (علاقة الإدارة – المنتخبين)؛
-بناء سياسات عمومية مندمجة وفعالة تحقق التقائية السياسات العمومية (علاقة الإدارة -الإدارة).
وفي هذا الصدد، يرتكز التصور الجديد للإدارة اللاممركزة على تنزيل مبادئ دستور يوليوز 2011 الذي بوء الجهة مستوى الصدارة في العلاقات بين مختلف الفاعلين المحليين، وجعلها فضاء للحوار والتشاور ولإعداد برامج التنمية وتتبعها.
وتأسيسا على المبادئ المذكورة وعلى التوجيهات الملكية السامية، يمكن اختزال الخطوط العريضة للتصور الجديد للإدارة اللاممركزة في المحاور التالية:
– توضيح دور الإدارات المركزية وحصرها في مهام التأطير والتصور والتوجيه وتقييم ومراقبة أداء الإدارات اللاممركزة، فضلا عن الدور المنوط بها في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية (مبدأ التفريع principe de subsidiarité)؛
– مواكبة الإصلاح الجهوي الأخير وإبراز المستوى الجهوي باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية، على أن تتولى الإدارات الإقليمية مهمة تنفيذ السياسات العمومية وإنجاز برامج التضامن والتماسك الاجتماعي، وكذا المواكبة والمساعدة التقنية لفائدة الجماعات الترابية؛
– إمكانية تجميع المهام الإدارية المشتركة، المنسجمة أو المتكاملة عن طريق خلق إدارات جهوية تكون قادرة على إنجاز مشاريع جهوية تستلزم توحيد العمل وتظافر جهود عدة مصالح تابعة لنفس المستوى الترابي؛
– توضيح مجال تدخل وحدود العلاقات بين الفاعلين في مجال اللاتمركز من إدارات مركزية ومصالحها اللاممركزة وسلطات محلية، تقوم على أساس تفويض صلاحيات اتخاذ القرار، مع تدعيم مجال تنسيق أنشطة المصالح قصد ضمان وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي.
وتتضح أهمية اللاتمركز الإداري في محاولة استجلاء دوره الرئيسي الذي يعد جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشامل والعميق الذي أصبحت تطالعنا به الدولة الحديثة.
ومن أجل التطرق بشكل مفصل لأهم الآليات المواكبة لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، سنتطرق لميثاق اللاتمركز الإداري الجديد ورهان إنجاح ورش الجهوية المتقدمة (أولا)، ثم سنتطرق للاتمركزالإداري كدعامة أساسية لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة (ثانيا).
أولا: ميثاق اللاتمركز الإداري الجديد ورهان إنجاح سياسة الجهوية المتقدمة
تنفيذا للاختيارات الإستراتيجية المعبر عنها من خلال الدستور الجديد لسنة 2011، وللتعليمات الملكية السامية التي تحث على تدعيم مسلسل اللاتمركز الإداري قصد مواكبة الدينامية الجديدة التي تعرفها الجهة، فإن المجهودات المبذولة في مجال تنظيم المصالح الإدارية تتجه نحو تجاوز وضعية تمركز الاختصاصات والسلط التقريرية والوسائل المادية والبشرية على مستوى الإدارات المركزية، وذلك لفائدة المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية عبر تدعيم مسلسل اللاتمركزالإداري من خلال ميثاق للاتمركز الإداري الصادر مؤخرا [5]وترسيخ مفهوم الجهة الذي يجعل من نظام اللامركزية والجهوية أداة فعالة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولمقاربة موضوع اللاتمركز الإداري سنطرق لتجليات ميثاق للاتمركز الإداري لسنة 2018 (أ)،ثم أهم الإكراهات المرتبطة بأسلوب اللاتمركز الإداري (ب).
أ: تجليات ميثاق اللاتمركز الإداري لسنة 2018
لقد جاء إصدار المرسوم رقم 618.17.2 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، بمثابة إصلاح مهم ومهيكل سيتم تنفيذه بشكل تدريجي ووفق خارطة طريق محددة. ولابد من الإشارة هنا إلى أن هذا الميثاق يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في العديد من الخطب كان أخرها خطاب العرش لسنة 2018،كما يأتي أيضا استنادا لمقتضيات دستور 2011 والذي بوأ الجهة مستوى الصدارة بين مختلف الفاعلين المحليين.وفي هذا الإطار نهجت الدولة سياسة اللاتمركز الإداري اعتمادا على المقاربة الأمنية التي تجعل من وزارة الداخلية وممثليها في العمالات والأقاليم ( العمال – الولاة ) مركز الثقل والأداة المنفذ لهذه السياسة، كما أن مهمة السلطة المركزية لا تنحصر في إدارة الشأن العام انطلاقا من المركز فقط، بل يمتد نشاطها عبر أرجاء الوطن من خلال ما يسمى بالمصالح الخارجية للوزارات.[6]
ولمؤسسة العامل دور استراتيجي في الهرم الإداري المغربي، فالعامل اكتسى هذا الدور انطلاقا من تعيينه بظهير وكذا من خلال مجموعة من النصوص والقوانين التي تصب في إطار تعزيز مكانته، وجعله قطبا رئيسيا يضطلع بوظائف سياسية وإدارية تتجلى في تمثيليته للملك من جهة، وللحكومة من جهة أخرى، فدستور 2011 نص في الفصل 145 على “…يقوم الولاة والعمال تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية ويسهرون على حسن سيرها”.[7]
كما ركز ميثاق اللاتمركز الإداري الصادر في دجنبر 2018 من خلال مادته السادسة، على الدور المحوري لوالي الجهة في تنسيق عمل المصالح اللاممركزة للدولة، من خلال السهر على حسن سيرها ومراقبتها، وتوخي النجاعة والفعالية في أداء مهامها، وذلك بهدف التطبيق الأمثل للتوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال إعادة تنظيم مصالحها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، وتحديد المهام الموكولة لهذه المصالح، ومن أجل التوطين الترابي للسياسات العمومية عن طريق أخد الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، وذلك لمواكبة التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة، القائم على الجهوية المتقدمة، والعمل على ضمان نجاعته وفعاليته.
وبالإضافة إلى الدور الإداري، فإن للولاة والعمال دورا اقتصاديا وتنمويا يتجلى في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان مواكبة المصالح اللاممركزة للدولة للجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية، وفي هذا الصدد يشرف الولاة والعمال على تحضير البرامج والمشاريع المقررة من قبل السلطات العمومية أو تلك التي كانت موضوع اتفاقيات عمومية أو عقود مع هيئات أخرى، ويسهرون على ضمان التقائيتها وانسجامها وتناسقها[8]. كما يعهد إليهم، كل في دائرة اختصاصه، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ المصالح اللاممركزة للدولة لمهامها وللالتزامات الملقاة على عاتقها وقيامها بإنجاز البرامج والمشاريع المذكورة.
إضافة إلى كل ما سبق فإن لمؤسسة العامل سلطة أخري يصطلح عليها بسلطة الحلول التي تسمح للوالي أو العامل طبقا للقانون للقيام ” بصفقة تلقائية “مقام رئيس منتخب بعد تغيب هذا الأخير ورفضه القيام بواجبه.
كما يتجلى اللاتمركز كذاك من خلال تمثيلية المصالح الخارجية للوزارات والتي تتمثل في المندوبيات والمديريات الإقليمية المتواجدة في العمالات والأقاليم، والتي ينحصر دورها في تنفيذ سياسة الحكومة وتطبيق جميع القرارات والتوجيهات الصادرة عن الإدارة المركزية[9].
وفي هذا السياق نشير إلى أنه باستثناء وزارة الداخلية، فإن تمثيلية باقي المصالح تبقى جد ضعيفة وناقصة، مع توفر بعض الوزارات الكبرى على تغطية مكثفة نسبيا على مستوى التراب الوطني (وزارةالعدل، الصحة، المالية، التعليم…). أما بالنسبة لباقي الوزارات، فانتشار تغطية المصالح الخارجية ليست منجزة إلا بنسبة 40% إلى 60% تقريبا[10]، مما يدل على غياب سياسة حقيقية ومعقلنة للاتركيز.
ب: عوائق اللاتركيزالإداري
يكمن تعثر اللاتركيز الإداري وعدم بلوغه المرامي المقصودة منه في عوائق موضوعية(1) وأخرى ذاتية (2).
1 – العوائق الموضوعية
كما سبقت الإشارة أنه باستثناء وزارة الداخلية التي تحوز على أكبر تمثيلية لها في مختلف الأقاليم والعمالات، فإن أغلب الوزارات بقيت قاصرة عن بلوغ هذا الهدف، وتمثيليتها إما غائبة بشكل مطلق وهذا هو حال الوزارات الحديثة وإما خفيفة ولا تشمل مجموع التراب الوطني. ويمكن القول إن الخريطة الإدارية المغربية كان لها دور كبير في إعاقة سياسة اللاتمركز والحد من تطويرها وذلك من حيث طبيعتها (التعقيد والازدواجية، وكثرة المستويات التسلسلية )، ومن حيث هندستها إذا لم تأخذ بعين الاعتبار منطق الشمولية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا من حيث طريقة إعدادها، إذ يغيب التنسيق والتناغم وأخيرا من حيث استقرارها، إذ تعرف تقسيمات تخضع دوما للهاجس الأمني مما يهمش دور الوزارات الأخرى على حساب وزارة الداخلية، حيث قلة الوسائل البشرية والمادية… وعدم ملائمة مناطق تدخل المصالح الخارجية مع التقسيم الإداري الجديد وتحفظ المرافق الوزارية في ميدان تفويض السلط والوسائل التي بدونها لا يمكن الحديث عن سياسة اللاتمركز[11].
عائق آخر يضاف إلى الأول ويتعلق بغياب التنسيق بين المصالح الخارجية للوزارات، حيث إن المبادرات المعلنة في هذا الشأن تبقى انفرادية ومرتبطة بالظرفية وبأولويات كل وزارة على حدة، وكذا بالوسائل المتاحة، الشيء الذي يجعلها مبادرات خاصة منعزلة ومفتقدة لخطة منهجية تراعي البرامج التنموية اقتصاديا واجتماعيا وتطبعها بالانسجام المطلوب. فبعض المصالح الخارجية التابعة لعدد من الوزارات لا تعمل في نفس الفضاءات الجغرافية وهو ما يجعلها لا تساعد على تنفيذ أفضل للبرامج التنموية المندمجة، وتحد من الإنجاز المنسجم للأعمال المقدمة في مختلف القطاعات.
إن كل هاته العوامل لا تعكس في الحقيقة سوى عدم الرغبة في التعاون، وهو ما يؤدي إلى التساؤل عن الجدوى من اعتماد الجماعات المحلية على المصالح التقنية للدولة، إذا لم تكن لها السلطة الفعلية والإرادة الحسنة لذلك، لأنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية محلية وجهوية في ظل هذا التنافر.
2 – العوائق الذاتية
إن إعطاء الأهمية القصوى من طرف الفكر الإصلاحي المغربي لسياسة اللامركزية الإدارية باعتبارها وسيلة لمقاومة التجاوزات البيروقراطية قد همشت اللاتركيز بإعطائه صورة العنصر المحتقر ضمن سياسة الإصلاح الإداري،كما أدى الفكر الموروث عن المرحلة الاستعمارية القديمة إلى ترسيخ احتكار السلطة على مستوى الإدارة المركزية، حيث تحتفظ الإدارة باختصاصات هامة على المستوى القانوني، كما أدى إلى عدم الثقة والتردد الشيء الذي جعل رجال الإدارة يرون في اللاتركيز نوعا من السحب لاختصاصاتهم وبالتالي التنقيص من هبتهم وامتيازاتهم، وهو أمر لا يمكن تصوره في العقيدة البيروقراطية، لذلك تشكل أية مطالب في هذا الشأن نوعا من المضايقات السياسية التي لا يمكن الخضوع والاستجابة لها من طرفهم، ناهيك عن الخوف من انفلات زمام المبادرة من المركز والحرص على استمرار تبعية المحيط للمركز.
وعموما، فإن العوائق الذاتية والموضوعية المشار إليها، قد جعلت الأهداف المعلن عنها بخصوص اللاتركيز من قبيل – تقريب الإدارة من المواطنين – اقتصاد النفقات والوقت، السرعة في اتخاذ القرار، إشراك المصالح الخارجية في اتخاذ القرار…، مجرد شعارات لا تصمد أمام عناد الواقع، وتكشف عن غياب سياسة واضحة ومعقلنة للاتركيز الإداري وعن قصور الاختيارات المتبعة في هذا الشأن رغم المحاولات الرامية إلى تطوير مسلسل اللاتركيز ليتماشى مع المتغيرات الجهوية والدولية.[12]
ثانيا: اللاتمركز الإداري دعامة أساسية لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة
يعتبر المجال الجهوي المجال الأمثل والإطار المناسب للحديث عن سياسة اللاتمركز الإداري، والتي من شأنها أن تقوم بتفعيل هذا الأسلوب من التدبير الإداري المحلي و الجهوي الذي أصبح لا غنى عنه في الوقت الحالي، وذلك من أجل الدفع بسياسة اللامركزية،بحيث نصت المادة 17[13]من ميثاق اللاتمركز الإداري على ضرورة إعادة صياغة مختلف التشريعات المتعلقة بمالية الدولة وتنظيم القطاعات الوزارية واختصاصاتها وقواعد التفويض ونظام الوظيفة العمومية بالشكل الذي يتيح لرؤساء المصالح اللاممركزة إمكانية التدبير الجيد للمسار المهني للموارد البشرية التابعة لهم. من خلال إعداد جدول بياني يهم توزيع الموارد البشرية بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة التابعة لها على المستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم.
ويستند اللاتركيز الإداري على أسس قانونية تتمثل في التفويض كأسلوب لعدم التركيز الإداري(أ)، وتوفير الموارد المالية والبشرية (ب).
أ- التفويض كأسلوب لعدم التركيز الإداري
يعد التفويض أسلوبا من الأساليب القديمة التي يلجأ إليها الرؤساء الإداريون من أجل التخفيف من الأعباء، على اعتبار أن تدخل السلطات العمومية أصبح ضرورة في كل المجالات، ويشكل التفويض أهم وسيلة يتحقق بها عدم التمركز الإداري.
والتفويض بإجماع الفقهاء والباحثين في القانون الإداري، هو عملية من العمليات الإدارية التي لها أثر كبير على الأداء والإنجاز الإداريين، وعلى تحديث وتطوير العمل الإداري باعتبار الأبعاد السيكولوجية و التدبيرية والثقافية التي يتضمنها،وترجع أهمية التفويض إلى النتائج المهمة التي يحققها، والتي تنعكس على العمل الإداري عند تطبيقه بل إنها تشكل جوهر عدم التركيز الإداري.
ولم يستقر التفويض في إطار نوع واحد بل تعددت أشكاله وتنوعت مضامينه تبعا لمقتضيات العمل، حيث اجتهد الفقه في التمييز بينها وإيجاد تسميات ملائمة لها، إلا أن أهمها حسب أغلب الباحثين يظل في التفويض الشخصي المتعلق بتفويض الإمضاء، ثم التفويض الوظيفي المتمثل في تفويض الاختصاص.
1- تفويض الإمضاء:
يقصد بتفويض الإمضاء أو التوقيع نقل العمل المادي في التوقيع باسم المفوض، فهو لايؤدي إلى إحداث تغيير في توزيع الاختصاصات كما لا يترتب عنه نزع الاختصاص من صاحبه الأصلي، حيث يجوز له ممارسته في أي وقت شاء، ذلك أن المفوض هنا يعهد للمفوض إليه بالتوقيع نيابة عنه، ولكنه لا يتنازل عن السلطات المفوضة ويظل المفوض إليه تحت مسؤولية المفوض، فهذا النوع من التفويض يتحقق من خلال ترخيص صاحب الاختصاص لمسئول أو مساعد تابع له بالتوقيع نيابة عنه على بعض التصرفات والوثائق الإدارية.
ويعتبر تفويض التوقيع تفويضا شخصيا، لأن المفوض يختار المفوض إليه شخصيا وبذاته حيث ينتهي هذا النوع من التفويض بانتهاء وظيفة أي طرف من الطرفين، نظرا لصفته الشخصية، أي أن مدة التفويض رهينة بطول أو قصر المدة التي يبقى فيها المفوض أو المفوض إليه في وظيفته , كما يترتب أيضا عن الصفة الشخصية لتفويض التوقيع واعتباره مجرد تنظيم داخلي أن يظل المفوض مسئولا عن قرارات المفوض إليه، فيما عدا ما يترتب على قرارات هذا الأخير من مسؤولية تأديبية، يضاف إلى ذلك أن المفوض يستطيع أن يتدخل ويلغي أو يعدل قرارات المفوض إليه[14].
2- تفويض الاختصاص
يعتبر تفويض الاختصاص لدى الباحثين في القانون الإداري حجر الزاوية في نظرية التنظيم الإداري، إذ بدونه لن يتم توزيع العمل داخل الإدارات توزيعا دقيقا ومنظما، فبواسطته يحصل معاونو الرئيس الإداري على اختصاصات محددة، لكي يقوموا بها بصفة دائمة، وبذلك فإن تفويض الاختصاص يؤدي إلى تخلي المفوض عن الاختصاصات التي فوضها، فلا يستطيع أن يمارسها إلاإذا ألغي هذا التفويض، ويملك المفوض إليه سلطة أصيلة في هذا الشأن بحيث لا يستطيع المفوض أن يمارس إزاءها اختصاصا منافسا، وإلا اعتبر ذلك تجاوزا للسلطة[15].
ونظرا لما يمتاز به هذا النوع من التفويض من صفة مجردة حيث يوجه إلى شاغل الوظيفة وليس إلى شخصه، فإنه لا يحتاج إلى تجديد صريح للاستفادة منه، ومن ثم لا ينتهي بانتهاء وظيفة أي طرف من طرفي التفويض.ولتفعيل اللاتركيز ينبغي إزالة بعض المعوقات، التي نذكر منها على وجه الخصوص:
– تخوف الإدارات المركزية من أن تخسر امتيازاتها وسلطتها؛
– ميل المغاربة إلى حل مشاكلهم على المستوى المركزي؛
– تهرب المصالح الخارجية من تحملها مسؤوليات ومهام إضافية؛
– غياب خطة موحدة لإنجاز اللاتركيز على مستوى الوزارات، إذ يلاحظ أن هناك تفاوتا كبيرا في إنجاز اللاتركيز.
وحتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة من الجهوية المتقدمة في الميدان الإداري على الأقل يجب توسيع نطاق المندوبيات الجهوية وترسيخ الممارسة العملية على هذا المستوى، من أجل مساعدة الدولة في إطار المشاريع الكبرى التي تجد بعين المكان من سيقدم لها المعلومات الكافية والمعطيات والدراسات.
كما يجب تحديد وضعية رؤساء المصالح غير المتمركزة على المستوى الجهوي بالنسبة لعلاقتهم بالوزراء من جهة وبوالي الجهة ثانية، إلا أنه بالموازاة مع ذلك ينبغي تحديد إطار عمل المندوبيات ومنح التفويض لرؤساء المصالح الخارجية في البت والتقرير بغية ضمان سرعة الإنجاز[16].
وبالموازاة مع إعطاء المندوبيات الجهوية صلاحية البت في عين المكان في أغلب القضايا التي تطرح عليها، يقتضي الأمر وجود تنسيق محكم على المستويين الجهوي بين الهيئات المنتخبة محليا وجهويا، وبين مختلف ممثلي المصالح الخارجية للوزارات على صعيد اللاتركيز[17]، وأن تكون هناك مرونة وروحا وطنية عالية للتعامل وحل المشاكل والاستجابة فعليا للحاجيات المحلية للسكان.
ب – توفير الإمكانيات المالية والبشرية
لتجاوز اختلالات نظام اللاتركيز الإداري، لابد من توافر عنصرين أساسيين لايقلان أهمية عما سبق، ويتعلق الأمر بضرورة تمكين المصالح غير الممركزة من الموارد المالية والبشرية اللازمة لإنجاز المهام المرسومة لها.
1-الموارد المالية:
إن ما ينبغي الإشارة إليه وعدم تجاهله هو أن الإدارات المركزية تتردد في تفويض التصرف في الاعتمادات المالية لفائدة المصالح غير الممركزة، فالالتزام النهائي بالنفقات يبقى رهينا في أغلب الأحيان بالموافقة القبلية للإدارة المركزية وهو وضع لايساير مطلقا المتطلبات العملية للاتركيزالإداري، ذلك أن 35% من المصالح غير الممركزة تظل تابعة وبكيفية مطلقة للإدارات المركزية سواء على مستوى التسيير أو على مستوى التجهيز، من هذا المنطلق أصبح لزاما تمكين المصالح غير الممركزة من الموارد المالية الكافية للنهوض بأنشطتها من خلال إعادة النظر في الآليات التي يقوم عليها هذا التوزيع.
وتفويض الاختصاص وما يلزمه من اعتمادات مالية، ركزت عليه أيضا اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة في مقترحاتها، وذلك بغية تمكين المسئولين عن المصالح الخارجية من صلاحيات تقريرية تجعلهم قادرين على الوفاء بما يلتزمون به بكل مصداقية، والاستجابة لرغبات مختلف الفاعلين على المستوى الترابي.
2- الموارد البشرية
تعد الموارد البشرية الرأسمال الأساسي للتنمية، فهي لاتقل أهمية عن الموارد المالية إن لم تكن أكثر منها، خاصة في وقتنا الحالي الذي يجمع فيه الكل أن العنصر البشري هو ثروة المستقبل بامتياز، ومن هنا تأتي أهمية وضرورة توفر المصالح الخارجية على الموارد البشرية الضرورية لكي تتمكن من ممارسة ملائمة وفعالة لمهامها الجديدة المنوطة بها، وذلك من خلال إعادة انتشار الموظفين المتمركزين وخاصة منهم المؤهلين الذين يمكن أن يساعدوا على الدفع إلى الأمام من أجل الوحدة الأساسية المتمثلة في الجهة وتحقيق تنمية محلية مستديمة ومنتجة ومتكاملة.
وترشيدا للهياكل التنظيمية وللموارد البشرية والمالية،حث ميثاق اللاتمركز الإداري القطاعات الوزارية التي لا طاقة لها بتمثيل ترابي لا ممركز رغم حاجياتها إليه في مختلف الجماعات الترابية من جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة حضرية أو قروية،أن تفوض ذلك إلى إدارات أخرى متجانسة معها تقنيا ذات الحجم والوسائل الكافية للوفاء بهذا الغرض، وذلك من خلال اتفاقيات تبرم بين الوزارات المعنية.
إن تكريس الجهوية وجعلها إطارا فاعلا لتحقيق التنمية تطلب من الدولة منح الجهات مزيدا من الحرية والاستقلال المالي والإداري، وتعزيز مواردها المالية والبشرية، والتخفيف من حدة الوصاية والرقابة على مقرراتها وأعمالها، وتمكينها من تبني برنامج للتنمية الجهوية وتفعيل مشاريعه بمعية باقي الشركاء على الصعيد الجهوي.
المحور الثاني: أسس ومبادئ الجهوية المتقدمة كما يحددها القانون التنظيمي 111.14.
جاء مشروع الجهوية المتقدمة امتثالا للإرادة الملكية السامية والالتزام الحر والسيادي للدولة المغربية، وذلك بغية “الارتقاء من جهوية ناشئة إلى جهوية متقدمة ذات جوهر ديمقراطي تنموي”، فقد كانت دعوة الملك للجنة الاستشارية للجهوية، لإيجاد نموذج مغربي-مغربي للجهوية يكون نابع من خصوصيات المغرب.[18]
كما حث الملك على كون الجهوية المنشودة “ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطور وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المندمجة”. كما أن مشروع الجهوية يتوخى منه أن يكون مدخلا لإصلاح عميق لهياكل الدولة من خلال السير على درب الديمقراطية، والمقاربة التشاركية والتنمية الاجتماعية والتحديث السياسي والإداري وكذا الحكامة الترابية الجيدة، أي أن الغاية الأساسية من الجهوية هي أن تكون “انبثاقا لدينامية جديدة للإصلاح المؤسسي العميق”.
إن الغاية من مشروع الجهوية المتقدمة ليست فقط تمكين المواطنين من تدبير أمورهم بأنفسهم، انطلاقا من الموارد والصلاحيات المتوفرة لتحقيق التنمية المجالية، بل تتجاوز ذلك لحد العمل على منح جل الجماعات الترابية استقلالا مهما في تدبير الشأن المحلي بهدف تحقيق متطلبات الساكنة المحلية عن طريق إشراكها في جميع القرارات المتخذة تفعيلا لأهداف دستور 2011، وللغايات التي أحدث لأجلها مشروع الجهوية المتقدمة.
بناء على ما سبق سنتطرق إلى الجهوية المتقدمة من خلال دستور 2011 (أولا)، على أن نتناول أهم مرتكزات الجهوية المتقدمة على ضوء القانون التنظيمي للجهات 111.14 (ثانيا).
أولا: الجهوية المتقدمة على ضوء دستور 2011
يتطلع ورش الجهوية إلى تمكين المغرب من جهوية متقدمة، ديمقراطية الجوهر مكرسة للتنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، تشكل مدخلا لإصلاح عميق لهياكل الدولة من خلال السير المتدرج على درب اللامركزية واللاتمركز، والديمقراطية التشاركية، والتحديث الاجتماعي والسياسي والإداري للبلاد والحكامة الجيدة[19]. ولهذه الأسباب فقد جاء دستور فاتح يوليوز2011، لتكريس ورش الجهوية المتقدمة من خلال التنصيص على مقتضيات متقدمة في هذا المجال.
لقد تضمن الدستور الجديد مجموعة من المقتضيات المهمة والتي ارتقت بالجهات وجعلتها تحتل مرتبة أساسية ومحورية يقوم على أساسها التنظيم الترابي للمملكة، وهكذا نجد الدستور في الفصل الأول منه قد نص في فقرته الأخيرة على أن:”التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي” يقوم على الجهوية المتقدمة ولم يكن هذا النص موجودا في الدساتير السابقة، حيث تفيد دسترة هذا المقتضى جعل الجهوية المتقدمة أساس التنظيم الترابي[20].
فعلى مستوى الشكل رفع الدستور الجديد الجهة إلى مرتبة الجماعات الترابية، وتم استبدال التسمية القديمة للجماعات المحلية ب”الجماعات الترابية”[21]، ذلك أن التراب ليس فقط مجالا للإعداد والتنظيم، بل هو أحد المداخل الجديدة للسياسات العمومية الناجعة، ومحددا مرجعيا وفاعلا في شروط التنمية المجتمعية المنشودة. كما تبوأت الجهة في إطار الجهوية المتقدمة مكان الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية.
وقد خصص دستور 2011 بابا كاملا للجهات والجماعات الترابية، عكس دستور1992[22]الذي خصص فقط ثلاثة فصول، تقدم تعريفا للجهة كجماعة محلية، ولدور العمال داخل الجهات، لكن الفصول التي تضمنها دستور 2011 تشير إلى مجموعة من المقتضيات التي ستتميز بها الجهات، فإذا ما رجعنا إلى الفصل 135 من الدستور المذكور، فإننا نجد من بين أهم المستجدات التي تضمنها هذا الفصل هو تشكيل مجالس الجهات وتدبير شؤونها بكيفية ديمقراطية، وذلك عن طريق الاقتراع العام المباشر، وتضمين هذا المقتضى يهدف إلى تقوية التمثيلية والمشروعية الديمقراطية للمجالس الجهوية.
وهو أمر ينسجم والمبادئ الأساسية التي حكمت التعديل الدستوري لسنة 2011 من قبيل ربط المسؤولية بالمحاسبة التي تشكل الدعامة الرئيسية للتدبير الإداري، وتماشيا مع هذا المبدأ انتقلت سلطة اتخاذ القرار من ممثل السلطة المركزيةإلى ممثل السلطة المنتخبة، فنص الدستور على خيار الاقتراع العام المباشر لمجالس الجهات،وهي نفس التوصية التي كان قد تضمنها التقرير الختامي للجنة الاستشارية للجهوية الذي يؤكد على رغبة المشرع الدستوري في جعل هذه المجالس تعبر بشكل واضح عن إرادة الساكنة وتكتسب مشروعية انتخابها عن طريق صناديق الاقتراع.
وهذا ما أكده القانون التنظيمي للجهات، الذي نص على انتخاب أعضاء مجلس الجهة بالاقتراع العام المباشر[23]، وهو ما مكنه من إعادة النظر في تركيبة المجالس التي كان ينظر إليها على أنها كثل غير متجانسة وغير متضامنة، بالنظر لتركيبتها المتنوعة التي تتكون من أعضاء تختلف مصادر انتخابهم[24].
من جانب آخر نص دستور 2011 في الفصل 136 “على أن التنظيم الجهوي للمملكة يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن وذلك من خلال حرص المجالس الجهوية على إشراك القطاع الخاص، ومختلف الفاعلين في وضع التصورات، وتنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع التنموية، وتوفير المناخ الأمثل للاستثمار وخلق مناصب للشغل ورواج الأعمال.
كما تطرق هذا الفصل إلى تأمين مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، وذلك عن طريق وضع إطار مرجعي وفق مقاربة تشاركية محددة المبادئ والشروط والأساليب التي تقوم عليها الشراكة مع الجمعيات المؤهلة، ومن أجل تحقيق ذلك، أكد الفصل 137 من دستور 2011 على أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى ستساهم في تفعيل السياسات العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، وذلك لضمان نجاعة تدخلات الدولة في كل مستوى من مستويات التنظيم الترابي، وضمان سدادها في أعين المواطنين وفعالية وقعها. ويمكن للجهات أن تساهم في بلورة السياسات العمومية الترابية، إما بواسطة ممثليها بمجلس المستشارين أو في إطار إشراكها من طرف الدولة في بلورة هذه السياسات[25].
ومن أجل دعم التدبير الديمقراطي للشؤون الجهوية، نص الفصل 138 ولأول مرة أن رؤساء مجالس الجهات سيقومون بتنفيذ مداولات مجالسهم، كما أنهم سيتمتعون بصفة أمراء بصرف المداخيل والنفقات المتعلقة بتسيير المجلس الجهوي، كما سيضطلعون بالتنفيذ المباشر لقرارات المجالس ذات الطابع الإداري الفردي أو الجماعي، أو ذات الطابع المعياري، حيث توضع رهن إشارتهم وكالة لتنفيذ مشاريع الاستثمار التي يقررها المجلس الجهوي.
وفي إطار ترسيخ العمل التشاركي نص دستور 2011 في فصله 139 على” أن مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتسيير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها”.
ثانيا: مرتكزات تفعيل الجهوية المتقدمة على ضوء القانون التنظيمي 111.14 الخاص بالجهات
شكلت الجهوية المتقدمة مرجعية دائمة في الخطب الملكية، التي تعتبر صفحة جديدة في نهج الإصلاحات المتواصلة والشاملة التي يعرفها المغرب راهنا، ونمط جديد في التدبير الترابي للدولة يشمل كل المناطق وفي مقدمتها الصحراء المغربية. وهو ما يجعل من الجهوية المتقدمة كتصور جديد يستجيب لمطالب العديد من الفاعلين بتطوير النظام الجهوي، وذلك بالعمل على ترسيخ جهوية متقدمة بجهات المملكة تراعي الخصوصية الطبيعية، التاريخية، الإثنية، واللغوية… لكل جهة داخل التراب الوطني في إطار من التعاون و التكامل الجهويين، مستندة إلى العديد من المبادئ التي تشكل مرجعيتها الأساسية مثل عناصر الوحدة والتضامن والتوازن واللاتركيز الواسع و غايتها في نهاية المطاف تحقيق جملة من الأهداف كترسيخ الحكامة المحلية وتعزيز إدارة القرب وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة.
لقد نص الخطاب الملكي ليوم 3 يناير 2010 على أن “الجهوية المتقدمة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري بل هي توجه حاسم لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة “. كما وضع الخطاب أربعة مرتكزات للتصور الذي يتعين أن تضعه اللجنة الاستشارية للجهوية تتمثل فيالوحدة والتضامن، ثم التوازن واللاتمركز الواسع والتي تمثل أهم مرتكزات القانون التنظيمي الجديد111.14 الخاص بالجهات.
أ- الوحدة
إن الوحدة هي التي تنبني على وحدة الوطن والتراب، التي تحيل في معناها الملكي إلى التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها في وحدة الدولة والوطن والتراب، وبالإمكان اعتبارها المرجعية الصلبة في كل توجه مستقبلي للجهوية المتقدمة، بل إن التجارب الدولية في هذا الإطار تؤكد على الأولوية التي يجب إعطاؤها لهذا المبدأ المحوري، الذي يجعل “وحدة الدولة” القاعدة الجامعة لاعتبارات التنوع المجالي والاثني والثقافي، فالجهوية الموسعة هي تأكيد ديمقراطي للتميز المغربي الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية المنصهرة في هوية وطنية موحدة[26].
وفي هذا الإطار، يجب أن لايغيب على الأذهان، المشاكل ذات الطابع السياسي التي تواجه المغرب، والتي يتعين إيجاد حلول لها بتوافق بين جميع المكونات الاجتماعية والسياسية والإدارية، وفي نظرنا فإن الجهوية المتقدمة تعتبر أهم إصلاح يستطيع حل الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية وكذا السياسية التي تعرفها مختلف جهات المملكة[27].
فمهما يكن، فقد حان الوقت لوضع حد لهذه الإشكالات المجالية بين مختلف جهات المملكة باعتماد مقاربة جهوية متقدمة كحل له، وذلك بخلق جهات لها من الاستقلالية ما يمكنها من تدبير شؤونها بكل استقلالية دون التخلي عن هويتها الوطنية والوحدة الترابية التي هي ثابت من الثوابت التي لايمكن المس بها أوالإساءة إليها، كما أن هذه الجهوية لا ينبغي أن تساهم في إعادة إنتاج الدولة التقليدية التي عرفها المغرب، فمعلوم أن الدولة التقليدية بطبيعتها كانت تفسح المجال أمام كثير من القبائل خاصة تلك البعيدة عن المركز للتمتع بنوع من الاستقلال النسبي عن السلطة، فهل يمكن اعتبار هذه التجربة التي عاشتها بعض القبائل في إطار ما يسمى بالدولة التقليدية نوعا من الجهوية التي نريد تطبيقها؟ عندما نتحدث الآن عن الجهوية المتقدمة فنحن نتحدث عنها في إطار تكريس دعائم الدولة الحديثة التي تقطع مع دعائم الدولة التقليدية[28]،أي أننا لا نتعامل مع الجهوية من منظور إثني أو قبلي كما كان عليه الحال في الدولة التقليدية، ولكننا نتعامل مع الجهوية المتقدمة كأسلوب جديد لتدبير علاقة سلطة المركز بمحيطها، وكذلك كأسلوب لتحقيق الديمقراطية المحلية ورفع تحديات التنمية.
إن الجهوية المتقدمة في إطار الوحدة الترابية، هو أرقى أسلوب للجهوية تمنح بمقتضاه إمكانية قيام مؤسسات مستقلة في ظل الوحدة الترابية ومتطلبات السيادة الوطنية، ومع انسجام تام واحترام لخصوصية كل جهة لتدبير شؤون جهتها حسب معطياتها وظروفها وإمكانيتها المادية والطبيعية والاقتصادية والبشرية[29].
ب-التضامن
التضامن بين الجهات أو التضامن الوطني، كلها مسميات لقاعدة متشابهة،وهي قاعدة “تضامن الدولة” إذ أن التنوع في الإمكانيات والوسائل يلزم أن يتوحد على مستوى دعم شروط تنمية الدولة الواحدة اقتصاديا واجتماعيا، وهذا مايستدعي استثمار كل جهة لمؤهلاتها على الوجه الأمثل مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق في مغرب موحد، فهناك اختلالات وهذا ما يفسر أسباب النزول بكل تأكيد. ومن بين هذه الاختلالات وجود تفاوت بين الجهات، حيث أن هناك جهات غنية تتوفر على موارد كبيرة وهناك جهات فقيرة، وبالتالي فالتساؤل المطروح عن إمكانية نجاح الجهوية المتقدمة بين مناطق غنية وأخرى فقيرة، وبالتالي فالتساؤل المطروح عن إمكانية نجاح الجهوية المتقدمة بين مناطق غنية وأخرى فقيرة، غير أنه وبالرجوع إلى التجارب الدولية التي تطبق نظام الجهوية، نجد أن هناك تفاوتا بين الإمكانيات الطبيعية والبشرية بين الجهات، فعندما نستحضر النموذج الإيطالي، نجد أن وضعية مناطق الشمال ليست هي وضعية مناطق الجنوب، كما أن هناك تباينا بين الجهات في إسبانيا كذلك[30].
وموضوع الجهوية المتقدمة يطرح في الواقع كحل لتجاوز هذه التفاوتات بين جهة وأخرى، خاصة وأن الحديث لا زال مستمرا عن مناطق المغرب النافع ومناطق المغرب غير النافع، لذلك يجب التعاطي مع الجهوية المتقدمة كوسيلة تمكن الجهات التي تعاني من خصاص على مستوى الموارد البشرية والطبيعية من تجاوز هذا الخصاص[31].وهي تفاوتات سعت الدولة جاهدة من أجل تجاوزها، من خلال سن ترسانة قانونية قوية، وفي مقدمتها القانون التنظيمي 111.14.
إن تعزيز الجهوية يقتضي بالضرورة المزيد من التضامن الترابي بين جهات المملكة،ذلك أن تمركز أماكن إنتاج الثروة في مناطق معينة يؤدي إلى عجز بعض الجهات عن تغطية احتياجاتها من حيث الإنفاق اعتمادا على مواردها الذاتية، وعلاوة على هذا التفاوت في المداخيل ينضاف التنوع الجغرافي الكبير الذي يعني لبعض الجهات تكاليف أكبر عند تقديم الخدمات العمومية ويتعلق الأمر على الخصوص بالمناطق الجبلية، حيث يتطلب فك العزلة عن الساكنة تكاليف باهظة، و تحقيقا لشرط التضامن الترابي فإن الحلول المطبقة في مختلف البلدان جاءت ثمرة لمسار طويل وخاص، اعتمد كقاعدة عامة لتحويل جزء من موارد الدولة نحو المستويات الترابية الأدنى، وهذا ما يفسر ارتفاع الموارد المحولة من الدولة نحو الجماعات الترابية في البلدان التي تتميز بلامركزية متقدمة،بحيث تمثل 60% من موارد الجماعات الترابية في الاقتصاديات الصاعدة و %30 في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE).
وعلى هذا الأساس فمشروع الجهوية المتقدمة المنبثق من التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 3 يناير 2010، يتطلب وضع منظومة للتضامن تتجاوز إلى حد بعيد الإطار الضيق والمحدود أحيانا لآليات الموازنة التي يراد منها بصفة عامة تقريب الموارد أو التحملات المالية للجهات الأكثر فقرا من متوسط التنمية السوسيواقتصادية،لأجل ذلك تم العمل في البداية على الرقي بالجهات التي تعاني من صعوبات تنموية إلى حد معقول فيما يتعلق بمستوى المعيشة قبل تبني منطق ملائمة الموارد.
وبموجب القانون التنظيمي 111.14الخاص بالجهات،تم إنشاء صندوق للتأهيل بهدف تحسين مؤشرات الجهات المتأخرة في المجالات المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين مثل الصحة والتعليم. كما تم إحداث آليتين إضافيتين من شأنهما تقوية التضامن الجهوي، ويتعلق الأمر أولا بمراجعة طرق توزيع التحويلات بهدف تعزيز قدرتها على تحقيق الموازنة، وثانيا إنشاء صندوق للتضامن لفائدة الجهات الأكثر تأخرا. وعلى هذا النحو يمكن الجزم بالتكامل والتضامن الاقتصادي بين الجهات الذي سيضمن النمو الاقتصادي المتكافئ والذي بدوره سيضمن النمو والاستقرار الاجتماعي والسياسي[32].
ج- التوازن
المقصود بالتوازن هو التناسق في الصلاحيات والإمكانيات وتفادي تداخل الاختصاصات بين مختلف الجماعات الترابية والسلطات والمؤسسات، فمقومات هذا المبدأ ينبغي أن تقوم على أساس تحديد الاختصاصات الحصرية المنوطة بالدولة مع تمكين المؤسسات الجهوية من الصلاحيات الضرورية للنهوض بمهامها التنموية مع مراعاة مستلزمات العقلنة والانسجام والتكامل، هذا التوجه يقابله مبدأ يقوم على قاعدة توازن الدولة المركزية التي تحتفظ في ظلها بمقومات الفعل السياسي وما يستتبعه من مهام واختصاصات، ولا تضخيما غير معقلن لصلاحيات الجهات، التي تبقى الفاعل المرجعي ضمن شروط التنمية[33].
إن تحقيق مبدأ التوازن على أرض الواقع بين مختلف الجماعات الترابية وخصوصا الجهات، سيجعلنا نحقق مبدأ الفعالية الذي يرتكز على النجاعة الاقتصادية وتسريع وتيرة النمو والرفع من العائدات الإجمالية للاقتصاد الوطني، فمن واجب الدولة أن تساعد الوحدات الترابية على تثمين عناصرها الإيجابية وإبراز مؤهلاتها بأفضل وجه، بدءا بالموارد البشرية مرورا بالتجهيزات والبنية التحتية والمرافق وانتهاء بالموارد الطبيعية، وتفعيل ذلك على أرض الواقع يتطلب:
- الفعالية الترابية الشاملة للخدمات العمومية الكبرى وللشبكات الوطنية للنقل والاتصال وتحويل الطاقة؛
- الفعالية الاقتصادية للمجالات الحضرية والقروية على المستوى المحلي؛
وهذين البعدين لا يمكن تحقيقهما إلا بالارتكاز على مبدأ التوازن.
ومفهوم التوازن مفهوم ساكن،ويمكننا أن نتحدث عن التوازن داخل جهة ما على سبيل المثال بمقاربة مؤهلاتها الطبيعية مع الاستغلال الذي تخضع له، كما يمكننا التحدث عن التوازن على المستوى الوطني لمقارنة توزيع النمو الديمغرافي، وهناك ارتباط وثيق تشكل من خلال مفهوم التوازن الجهوي أو التآزر المتفاوت في علاقتهما بالحكامة، بحيث أن المفهوم الأول يرتكز على أن الجهات والدولة هما الفاعلين الأساسيين في تدبير المجال، وفي المفهوم الثاني تظهر الجهات المتباينة النمو التي تخلق اللاتوازنات الترابية، وكانت ولازالت بعض الجهات الرائدة تحتكر على حساب باقي الجهات الأخرى، لذا فإن مبدأ التوازن يقوم على تمكين الجهات بالصلاحيات الضرورية لتقوم بمهامها في إطار العقلنة والانسجام والتكامل.
د- اللاتمركز الواسع
يجب الإقرار بأن مثل هذا المبدأ يمكن اعتباره مبدأ مواكبا للمبادئ الثلاثة الأولى،فإن ضرورته بالنسبة لتطور اللامركزية بالمغرب قد يبرر هذه الأولوية التي حظي بها ضمن المرتكزات الأساسية لنجاح كشروع الجهوية المتقدمة.
ذلك أن الخاصية العامة لعيوب اللامركزية الإدارية المغربية هو ضعف التوازن في الأهمية والاهتمام لكل من مبدأ اللامركزية واللاتركيز في التطور الإداري العام الوطني والذي أصبح يقتضي بالضرورة تبني قاعدة ” لاتركيز الدولة” والتي ستجعل المصالح العمومية للدولة مطبوعة هي الأخرى بمنطق اللاتركيز الميسر للقرب وتجويد الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، بل هذه الضرورة عجلت بإصدار ميثاق وطني لعدم التمركز في دجنبر2018، بنظام يعتمد مقاربة ترابية تقوم على أساس نقل صلاحيات مركزية للمصالح اللاممركزة وانتظامها في أقطاب تقنية جهوية.[34]
خاتــــمـــــــة:
إن إقرار مبدأ الجهوية في عدم التركيز واعتماد الجهة مستوى لأي عمل لا تركيزي وتخويل المسؤولين فيها سلطات تقريرية حقيقية، هو نابع من اعتبار المستوى الجهوي الإطار الأكثر ملائمة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والمناسب لتجديد أسلوب التدبير العمومي، فالمستوى الجهوي يمكن من عدم تفتيت مراكز القرار الترابية، ويخول المسؤولين إمكانية مباشرة وظائف التنسيق والبرمجة والتخطيط ومراقبة عمل المستويات الدنيا.
وفي هذا السياق تعتبر الجهوية المتقدمة حلا استراتيجيا لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، فالجهوية مدخل لإصلاح عميق لهياكل الدولة والتحديث الاجتماعي والسياسي والإداري، ولأجل تحقيق هذه الأهداف خطى المشرع مجموعة من الأشواط المهمة والإستراتيجية من أجل وضع ترسانة قانونية لتفعيل مشروع الجهوية المتقدمة، ويبقى أهم هذه القوانين، القانون التنظيمي للجهات 111.14 والذي خصها بهامش أوسع من الاستقلالية، كما أن إصدار ميثاق للاتمركز الإداري الأخير، من شأنه أن يعزز دور المصالح اللاممركزة في الإسهام إلى جانب الهيئات الجهوية المنتخبة في تحقيق التنمية الترابية للجهات.
وعلى هذا الأساس، فالانتقال الحقيقي إلى دولة الجهات لا يعني إقامة مجموعة من الجهات تتمتع بالاستقلالية عن المركز في بعض المجالات المحددة أو تلك المفوضة لها من قبل السلطة المركزية، بل منح الجهات صلاحيات وسلطات دستورية للارتقاء بنظام الجهة إلى مستوى متقدم من اللامركزية في إطار الدولة الموحدة، بمعنى الانتقال من الجهوية الإدارية إلى الجهوية المتقدمة المحددة دستوريا.
إن التغيرات والمستجدات التي كشفت عنها الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز، لم تلقي بضلالها على موضوع التعاون اللامركزي بغض النظر عن بعض المستجدات، والتحيينات الطفيفة التي همت مجموعة الجماعات التي تحولت إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات، وتمكين الجهات من تأسيس مجموعات فيما بينها، وتأسيس شركات التنمية الجهوية، والارتقاء بالتعاون إلى مبدأ دستوري.
كما أن المشرع لم يعمل على تأطير أعمال التعاون اللامركزي بنصوص قانوني خاصة، مكتفيا ببعض المقتضيات الغامضة، والفضفاضة الواردة على متن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث.
لائــحة المراجــــع:
- سعيد نكاوي: “ميثاق اللاتمركز الإداري والتدبير اللامتمركز للاستثمار”، الطبع: مطبعة الأمنية، الرباط، طبعة 2019.
- بوجمعة بوعزاوي:” التنظيم الإداري – الإدارة المركزية للدولة – الجماعات الترابية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط الطبعة الأولى، 2013.
- كريم لحرش: “الدستور الجديد للمملكة شرح وتحليل”، سلسلة العمل التشريعي والاجتهاد القضائي، العدد 3، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2012.
- جردان إدريس: “النظام القانوني للجهة بالمغرب وآفاق الجهوية المتقدمة”، مطبعة سيليك إخوان، طنجة. الطبعة الأولى. ماي 2011.
- إيمان داودي: “الوالي والعامل والتنمية المحلية بالمغرب”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، بالرباط، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، سلا، السنة الجامعية: 2014-2015.
- مليكة الصروخ: ” القانون الإداري “، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2010.
- أبوبكر الشرقاوي:” دور الجهة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية “، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المحمدية. 2016-2017.
- محمد العيساوي: ” واقع الجهوية بالمغرب وآفاق المأسسة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة القاضي عياض. كلية الحقوق للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مراكش. السنة الجامعية 2015-2016.
- علي الورضي: ” مستقبل السياسة الجهوية بالمغرب “، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس. السنة الجامعية 2014-2015.
- الليلي حسن:” القضاء المغربي في أفق تطبيق نظام الجهوية المتقدمة ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –أكدال– الرباط. السنة الجامعية 2013-2014.
- المساوي شاكر: ” مساهمة في دراسة الإدارة الاقتصادية المحلية بالمغرب”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد الملك السعدي، كلية الحقوق طنجة. 2010-2011.
- لمحمي لحبيب: ” السياسة الجهوية ورهان التحديث السياسي بالمغرب، جهة العيون بوجدور نموذجا “، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام. جامعة القاضي عياض، مراكش. السنة الجامعية 2009-2010.
- مصطفى قريشي:” الجهوية المتقدمة ورش مفتوح للحكامة الترابية “، مجلة مسالك للفكر والسياسة والاقتصاد، العدد 30/29 ، السنة 2015.
- علاوي عبد الخالق: ” مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية وإعداد التراب في ضوء دستور 2011 “، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، مارس – أبريل 2014.
- المكي السراجي: “اللاتركيز الإداري في إطار السياسة الجهوية الموسعة”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،عدد مزدوج 97-98. 2011.
- الدستور 2011 المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91.11.1 بتاريخ 29 يوليو.2011، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر،الصادر بتاريخ 30 يوليوز 2011.
- دستور 1992 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 155-92-1 الصادر بتاريخ 11 ربيع الآخر 1413 الموافق ل 9 أكتوبر 1992.الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4172 الصادر بتاريخ 16 ربيع الآخر 1413 الموافق ل 14 أكتوبر 1992. المعدل لاحقا سنة 1996.
- القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلقبالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.الصادرة بالجريدة الرسمية عدد6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.
- الظهير الشريف رقم 1.97.84 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) الخاص بالجهات، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4470، بتاريخ 24 من ذي القعدة 1417 ( 3 أبريل 1997).
- المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 الموافق ل 26 دجنبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، الجريدة الرسمية عدد، 6738، 19 ربيع الآخر 1440 الموافق ل 27 دجنبر 2018، ص 9787.
- المرسوم رقم 2.19.40 الصادر بتاريخ 24 يناير 2019 الخاص بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6746 مكرر.
الهوامش:
[1]– علاوي عبد الخالق: ” مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية وإعداد التراب في ضوء دستور 2011 “، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، مارس – أبريل 2014.ص 28.
[2]– ينص دستور 2011 في فصله الأول على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.
[3]– الليلي حسن:” القضاء المغربي في أفق تطبيق نظام الجهوية المتقدمة ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –أكدال– الرباط. السنة الجامعية 2013-2014.ص 89.
[4]– ومن جانب آخر اعتبر فقهاء القانون الدستوري أن ما تضمنه دستور 2011 من مرتكزات تؤسس لدولة المؤسسات التي يقوم نظامها الدستوري على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية، قد أطر أيضا لمبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي المرتكزات التي يمكن أن تشكل أسس تنزيل الجهوية المتقدمة بالمغرب.
[5]– مرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 الموافق ل 26 دجنبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، بالجريدة الرسمية عدد، 6738،19 بتاريخ ربيع الآخر 1440 الموافق ل 27 دجنبر 2018، ص 9787.
[6] – إيمان داودي: “الوالي والعامل والتنمية المحلية بالمغرب”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، بالرباط، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، سلا، السنة الجامعية: 2014-2015,ص65.
[7] – بوجمعة بوعزاوي:” التنظيم الإداري – الإدارة المركزية للدولة – الجماعات الترابية “، الطبعة الأولى، دار السلام- الرباط 2013، ص 130.
[8]– المادة 26 من ميثاق اللاتمركز الإداري الصادر في دجنبر 2018، مرجع سابق.
[9]– مليكة الصروخ: ” القانون الإداري “،مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الرابعة، الدارالبيضاء، 2010، ص: 143.
[10]– أنظر وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري: إعادة هيكلة الإدارة على ضوء الدور الجديد للدولة ودعم سياسة اللاتمركز الإداري، التقرير التركيبي المعروض على لجنة اللاتركيز الإداري وإعادة تحديد مهام الإدارة المناظرة الأولى حول إصلاح الإداري بالمغرب تحت شعار الإدارة المغربية وتحديات 2010، الرباط 7-8 ماي 2002، ص: 12.
[11]– ملف حول اللامركزية واللاتركيز، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق، الطبعة الأولى، العدد 25 1990، ص: 247.
[12] – كلثوم هتهوتي: ” الجهة بالمغرب ومتطلبات التنمية “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية الحقوق أكدال-الرباط، السنة الجامعية 2002/2003، ص: 60.
[13]– يمكن اعتبار المادة 17 أحد أهم المواد الواردة في ميثاق اللاتمركز الإداري إن لم تكن الأهم لأنها تؤسس لتحول كبير على مستوى إدارة المصالح اللاممركزة وفق توجه جديد يعزز مكانتها على صعيد المبادرة التنموية وتقديم الخدمات الأساسية وتنفيذ المشاريع عبر تمكينها من أدوات واضحة للعمل من خلال التحكم في الموارد المالية والتقنية والبشرية، والقدرة على اتخاذ القرار بشكل فعال بمعزل عن الإدارة المركزية التي تكتفي بوضع التصور العام، طبعا دون إغفال دور الولاة والعمال باعتبارهم مشرفين مباشرين على رؤساء المصالح اللاممركزة ومنسقين لأنشطة هذه المصالح وفق الفصل 145 من دستور 2011 والفقرة الثانية من المادة 5 للميثاق.
[14]-علي الورضي: ” مستقبل السياسة الجهوية بالمغرب “، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس. السنة الجامعية 2014-2015، ص 237.
[15]– بالنظر إلى الاجتهاد القضائي الفرنسي،وعلى الخصوص ما صدر عن مجلس الدولة الفرنسي يلاحظ أن هذا الأخير جعل من عملية توزيع الاختصاص (بواسطة التفويضأو بواسطة التشريع)حافزا أساسيا يلزم السلطة التنفيذية إتباع أسلوب عدم التركيز شريطة عدم المساس بالسير العادي لهرمية السلطة.
[16]– محمد العيساوي: ” واقع الجهوية بالمغرب وآفاق المأسسة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة القاضي عياض. كلية الحقوق للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مراكش. السنة الجامعية 2015-2016، ص 153.
[17]-المكي السراجي: “اللاتركيز الإداري في إطار السياسة الجهوية الموسعة”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،عدد مزدوج 97-98. 2011، ص129.
[18]– مصطفى قريشي:” الجهوية المتقدمة ورش مفتوح للحكامة الترابية “، مجلة مسالك للفكر والسياسة والاقتصاد، العدد 30/29 ص 25، السنة 2015.
[19]– كريم لحرش: الدستور الجديد للمملكة شرح وتحليل، سلسلة العمل التشريعي والاجتهاد القضائي، العدد 3، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2012، ص: 16.
[20]– للمزيد من التفصيل أنظر الظهير الشريف رقم 1-11-91 الصادر في 27 من شعبان 1432، الموافق 29 يوليو 2011 المتعلق بدستور المملكة لسنة 2011، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011 ص 3600.
[21]– الفصل 135 من دستور2011، مرجع سابق.
[22]– الظهير الشريف رقم 155-92-1 الصادر بتاريخ 11 ربيع الآخر 1413 الموافق ل 9 أكتوبر 1992، الخاص بإحداث دستور المملكة، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4172 الصادر بتاريخ 16 ربيع الآخر 1413 الموافق ل 14 أكتوبر 1992. المعدل لاحقا سنة 1996.
[23]– تنص المادة 9 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات على أن “يدبر شؤون الجهة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59،11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية…”
[24]– الظهير الشريف رقم 1.97.84 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) الخاص بالجهات، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4470، بتاريخ 24 من ذي القعدة 1417 ( 3 أبريل 1997).
[25]– إن تحقيق سياسات عمومية ذات بعد ترابي تفرض على السلطات الحكومية المكلفة بهذه القطاعات أن تسهر بطريقة منسقة على وضع سياسات عمومية ترابية في تفاعل وتضافر بين القطاعات وعليها أن تشرك في ذلك المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الاختصاص الترابي نفسه وكذا البنيات المنتخبة المعينة وعند الاقتضاء، القطاع الخاص.
[26]– علاوي عبد الخالق: “مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية وإعداد التراب في ضوء دستور 2011” المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، مارس – أبريل 2014.ص 45.
[27]– لمحمي لحبيب: ” السياسة الجهوية ورهان التحديث السياسي بالمغرب، جهة العيون بوجدور نموذجا “، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام. جامعة القاضي عياض، مراكش. السنة الجامعية 2009-2010. ص 56.
[28]– الرضواني محمد:” في الثقافة السياسية المغربية “، منشورات سلسلة بدائل قانونية وسياسية، مطبعة المعارف، الجديدة–المغرب، الطبعة الأولى، 2015. ص 26.
[29]– علي الورضي:” مستقبل السياسة الجهوية بالمغرب ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس. 2014-2015، ص 244.
[30]-الحيمرعبد السلام:” مسارات التحول السوسيولوجي في المغرب ” سلسلة شرفات الزمن،الدار البيضاء، الطبعة الثانية. 2013، ص 59.
[31]– بوجروف سعيد:” الجهة والجهوية بالمغرب أي مشروع لأي تراب؟، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2012، ص 85.
[32]– جردان إدريس: “النظام القانوني للجهة بالمغرب وآفاق الجهوية المتقدمة” مطبعة سيليك إخوان، طنجة. الطبعة الأولى. ماي 2011، ص 84.
[33]– المساوي شاكر: ” مساهمة في دراسة الإدارة الاقتصادية المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد الملك السعدي، كلية الحقوق طنجة. 2010-2011، ص 82.
[34]– تجلى تدعيم مسلسل اللاتمركز الإداري من خلال إصدار:
– المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 الموافق ل 26 دجنبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6738.
– المرسوم رقم 2.19.40 الصادر بتاريخ 24 يناير 2019 الخاص بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6746 مكرر.