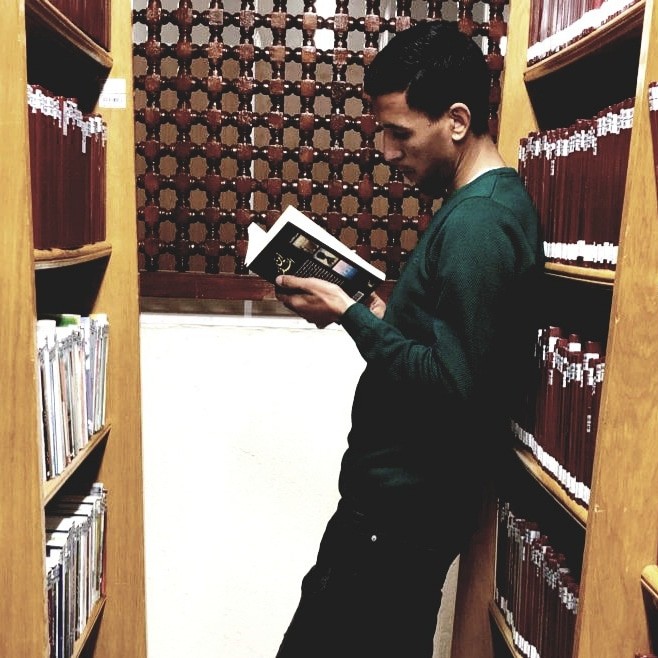القانون البرلماني وتأطير الممارسة البرلمانية بعد دستور 2011

حكيمة ماهير باحثة في القانون الدستوري وعلم السياسة.
يعتمد النظام البرلماني المغربي على نظام الغرفتين، وهو نسق مؤسساتي يمارس فيه مجلسان مكونان بطريقة مختلفة وظائف برلمانية وفق شروط يحددها الدستور والقوانين التنظيمية وكذلك وفق القوانين الداخلية لمجلسي البرلمان. فعلى إثر التحولات الاجتماعية التي شهدتها المنطقة العربية والتطورات السياسية الداخلية، حاول المشرع المغربي من خلال الوثيقة الدستورية لسنة 2011 دسترة مجموعة من الهيئات الجديدة، والرقي بمؤسسات أخرى قديمة وذلك عن طريق تقوية وتعزيز سلطاتها، ولقد كان للمؤسسة البرلمانية نصيب من هذه التعديلات التي شملت منحه اختصاصات واسعة في ميدان التشريع وكذلك تغييرات على مستوى الهيكلة الداخلية للبرلمان (اللجان، الفرق، المعارضة..)، حيث نص الدستور الحالي في بابه الرابع على السلطة التشريعية عوض البرلمان في الباب الثالث من دستور 1996، وهذا التغيير فإن دل فهو يدل على رغبة المشرع بالرقي بالمؤسسة البرلمانية والتأكيد على طابعها التشريعي، باعتبارها المحطة الرئيسية في بلورة أي مشروع أو مقترح قانون على أرض الواقع، كما أنه حاول تجاوز ثغرات الممارسات البرلمانية والعوائق التي كانت تحول دون أداء مؤسسة البرلمان لمهامها في السابق ومن ضمنها الاستغناء على اللجنة المختلطة.
إن أهمية هذا الموضوع تتجلى في المكانة المتميزة التي تحتلها المؤسسة البرلمانية داخل الهندسة الدستورية باعتبار نواب البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، لذلك فعلى هذه المؤسسة أن تمثل الشعب خير تمثيل. فعلى الرغم من أن الدستور المغربي لسنة 2011 قد خطا خطوة إيجابية لدعم العمل التشريعي للبرلمان على مستوى توسيع مجاله مقارنة بالدستور السابق، والارتقاء بالبرلمان إلى درجة المشرع الدستوري، وإعمال المقاربة التشاركية، إلا أن الممارسة البرلمانية قد كشفت عن مجموعة من الاختلالات والإشكالات الذاتية المتعلقة بأعضاء البرلمان (غياب البرلمانيين، ضعف المستوى الثقافي للنواب…) أو من خلال عدم وضوح بعض المقتضيات الدستورية والقانونية أو بطء العمل البرلماني في التنصيص على مقترحات القوانين، إضافة إلى ذلك فإن حصيلة العمل البرلماني خلال الدورات التشريعية تستدعي أكثر من ملاحظة حول التجربة البرلمانية عموما، وتطرح أكثر من تساؤل حول مدى مساهمة المستجدات الدستورية والقانون في تأطير الممارسة البرلمانية بعد دستور 2011 وجعلها أكثر عقلانية وجودة ونجاعة؟ للإجابة عن هذا السؤال والإحاطة بمختلف جوانب الموضوع، لابد من دراسة المؤسسة البرلمانية من خلال الوظائف التي تحددها المقتضيات الدستورية والقانونية بعد دستور 2011 من جهة، وكذا تحليل الأعراف والممارسات البرلمانية من جهة ثانية.
أولا: المؤسسة التشريعية والإشكالات الدستورية والقانونية
لم تستطع المؤسسة التشريعية أن تواكب الإصلاحات الدستورية وذلك من خلال عدة مستويات، حيث لا زال النظامين الداخليين للمجلسين دون المستوى المطلوب لتحقيق الملائمة الفعالة للمقتضيات الدستورية وتفصيلها، وتحقيق الانسجام المطلوب في المؤسسة التشريعية. ذلك أن هناك قوانين تنظيمية لم تفعل بعد، كما أن النظامين الداخليين للمجلسين لم يجيبا على مجموعة من لإشكالات والتي يمكن إدراج بعضها على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:
عدم تمكن النظامين الداخليين للمجلسين من الإجابة عن الإشكالية المتعلقة باقتراح كلا المجلسين لنفس مقترح القانون، مع العلم أنه لا يجوز أن يتم التصويت على مقترحين في نفس المجال، وفي انتظار الحل يلجأ المجلس إلى التفاوض السياسي لحل معظم هذه الإشكالات التي تطرح في هذا الصدد.
تواجه اللجان البرلمانية أيضا عدة قيود قانونية وسياسية بالرغم من الدور الهام الذي تلعبه على مستوى التشريع، فكل ما تقوم به اللجان الدائمة، من دراسة للقوانين و تفحصها و إدخال التعديلات عليها يبقى رهينا بالتصويت عليه في الجلسة العامة، التي تملك حق الإقرار أو الرفض، كما أن المشرع المغربي لم يكتف فقط بحرمانها من حق التعديل وإنما عمل بالمقابل على تقييدها من ممارسة حق المبادرة التشريعية، وبالتالي فإن هذه القيود القانونية تؤدي إلى شلل في حركية اللجان البرلمانية وفقدان مصداقيتها ومحدودية دورها، إضافة إلى ذلك فان طبيعة التركيبة البشرية للجان و شساعة اختصاصاتها تبقى عاملا آخر يأخذ بعين الاعتبار في محدودية هذه اللجان، كما أن هذه الأطر لا تتوفر على الخبرة التقنية لتفحص القوانين خاصة عندما تواجه قانونا تقنيا بطبيعته كقانون المالية، بالإضافة إلى أن الحكومة تملك آلية دستورية تستعملها في أي وقت للدفع بعدم قبول أو التصدي لأي تعديلات يتقدم بها النواب في اللجنة وذلك بموجب الفصل 77، في حين أن الدستور والأنظمة الداخلية لم تمنح البرلمانيين الحق في هذا النوع من الاعتراض، إن ما نص عليه هذا الفصل يمكن الحكومة من التحكم في المبادرة البرلمانية و توجيه ممارسة البرلمانيين لعملهم التشريعي، وفي نفس السياق تملك اللجان البرلمانية وسائل رقابية لمراقبة العمل الحكومي، وتتمثل أساسا في آليتي الاستماع والاستطلاع، إلا أن هذه اللجان تواجه عدة صعوبات تتجلى في محدودية هاتين الآليتين حيث إن عقد جلسات الاستماع لا يولد أية مسؤولية قد تؤدي إلى استقالة الحكومة، إذ لم تنص أي مادة على أية عقوبات زجرية في حق المستدعى الذي قد يرفض الحضور للاستماع إليه في شأن قضية معينة، ذلك أن النظامين الداخليين لا يجبران الوزراء أو من يمثلهم، على الحضور إذا تم استدعاؤهم وإنما جعلت هذه الإمكانية اختيارية فقط.
من ضمن القوانين الذي حمل في طياته عدة إشكالات هناك القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والتي تتمثل أساسا في تدخل الحكومة في توقيف عمل اللجنة عبر تحريك المتابعة القضائية وكذلك منها ما هو متعلق بطبيعة المجالات، كما أن مبدأ سرية اللجنة يتعارض مع الحق في الحصول على المعلومة، ويمكن الإشارة هنا أن تقرير مكتب التسويق والتصدير الذي أحدثته اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق تم عرضه على الجرائد قبل مناقشته وهذا الأمر يطرح تساؤلا حول نوعية المعلومات التي يمكن الإدلاء بها من طرف الناطق الرسمي للجنة أو المسائل التي يتم إخفائها.
تثير أيضا الهيئات الاستشارية إشكالات ومن ضمن هذه الهيئات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يعتبر هيئة استشارية بالأساس وذلك حسب الفصل 152، حيث أنه لم يتم تحديد علاقة هذا المجلس مع البرلمان فيما يخص المراقبة، وإمكانية أعضاء البرلمان من استدعاء رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لطرح عليه الأسئلة، مع العلم أن هذا المجلس له طابع استشاري، وبالتالي ليس هناك ما يؤكد وجود مراقبة على هذا المجلس ولكن تبقى العلاقة في إطار التعاون. ومن جهة أخرى لم يتم تفصيل أحكام الفصل 160 من الدستور والتي بمقتضاها يجب على مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية أن تقدم تقريرا عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل يكون موضوع مناقشة من طرف البرلمان. وقد أكد المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا) على أن هذه الهيئات والمؤسسات تبقى هيئات استشارية متمتعة باستقلاليتها، مما يجعلها لا تخضع للإشراف الإداري لوزير أو لوصايته، و عدم خضوعها للرقابة البرلمانية ما عدا ما يتعلق بالمصادقة على الميزانية.
ثانيا: تقييم أداء العمل البرلماني
إن تقييم الحصيلة التشريعية بعد دستور 2011، تستدعي التطرق إلى الإنتاج التشريعي من جهة ثم الرقابة البرلمانية للعمل الحكومي من جهة أخرى، وذلك للوقوف على مكامن الخلل في الممارسة البرلمانية بالرغم من أن الواقع يقتضي التعجيل بالتفعيل الملائم لمقتضيات الدستور حتى تصبح معه المؤسسة التشريعية فضاء حقيقيا للنقاش والحوار البناء وذلك للاستجابة لمتطلبات التحول الديمقراطي.
- فعلى مستوى الإنتاج التشريعي:
لم يستطع البرلمان المغربي بمجلسيه، الرفع من وثيرة العمل التشريعي كما و كيفا، حيث استمر التعامل السلبي مع مقترحات القوانين، فتبعا للمجالات المحددة التي تختص بها كل لجنة طبقا للنظام الداخلي لكل مجلس، نلاحظ وجود تفاوت في حجم الإنتاجية القانونية من لجنة لأخرى، وهو تفاوت يمكن اعتباره لا يرقى إلى المستوى المطلوب، مع استفحال وجود عدة إشكالات قانونية ودستورية، ومرد ذلك وجود عدد كبير من اللجان الدائمة داخل المجلسين مما يؤدي إلى تداخل بين اختصاصاتها من جهة وكذلك التفاوت في حجم الإنتاجية القانونية بين اللجان من جهة أخرى.
- على مستوى المراقبة البرلمانية:
فقد أبانت الحصيلة البرلمانية المتعلقة بالأسئلة البرلمانية لمراقبة عمل الحكومة عن محدودية تأثيرات هذه الأسئلة، التي لا يصل الأمر فيها إلى مستوى إثارة المسؤولية السياسية. كما أنه ليس هناك ما يجبر الحكومة على الإدلاء بجوابها على الأسئلة خلال العشرين يوما، مادام أنه لا يوجد جزاء دستوري، وكذلك ليس هناك وسيلة لمقاضاة الحكومة بسب التأخير أو رفض الجواب عن الأسئلة. ومما تجدر الإشارة إليه تهافت البرلمانيين على الأسئلة الشفوية وعزوفهم عن الأسئلة الكتابية لما توفره من إمكانية الظهور في التلفاز وإحراج الوزراء، وإذا كانت الأسئلة الشفوية وسيلة من وسائل مراقبة العمل الحكومي، فان هذه الأسئلة التي تطرح داخل البرلمان لا تنفذ إلى عمق المشكل وتظل دون فعالية ولا يترتب عليها أي أثر، حيث تبقى الأسئلة جامدة والأجوبة والتعقيب عليها تعد بطريقة مسبقة، كما أنها تتميز بالتكرار وتداخل الحسابات الضيقة، ففرق المعارضة لم تستثمر هذه الآليات الدستورية جيدا لتصبح معارضة قوية وفعالة، لكونها ما زالت سجينة عوامل نفسية على مستوى تقبل الوضع الحالي، وكذلك التشتت وغياب التنسيق فيما بينها خصوصا بين فرق أحزاب المعارضة. ومن جهة أخرى سجلت التجربة الحالية انتشار ظاهرة الغياب والتي باتت تؤرق المتتبعين، وهي ناتجة عن عدم وجود ضوابط أخلاقية و قانونية لدى الأحزاب السياسية والفرق النيابية.
أما فيما يخص اللجان النيابية لتقصي الحقائق فالممارسة البرلمانية قد أثبتت بأن تكوين هذه اللجان من قبل أحد مجلسي البرلمان، تعد مبادرة محدودة الآثار، إذ يكتفي فقط بعقد جلسة عمومية في المجلس المعني لمناقشة التقرير، دون أن تترتب عن ذلك أية نتائج سياسية قد تهدد استمرارية الحكومة في ممارسة عملها، إضافة إلى وجود صعوبات واقعية تواجه هذه اللجان، كبطء إمدادها بالوثائق وصعوبة الولوج للأرشيف واستدعاء الشهود، وفي هذا الصدد يمكن استحضار اللجان النيابية لتقصي الحقائق في ظل الدساتير السابقة التي لم تتعدى ثمانية لجان والتي كانت بمبادرة من طرف البرلمان، كقضية أحداث فاس، وقضية مخيم اكديم إزيك بالعيون، وقضية القرض العقاري و السياحي، وقضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقضية مكتب التسويق و التصدير….ولم يتم إصدار أي لجنة نيابية لتقصيالحقائق طبقا لأحكام الفصل67 من الدستور خلال الولاية التشريعية الحالية بالرغم من تزايد المهام الاستطلاعية للجان النيابية الدائمة خلال سنة 2012 ومنها: مهمة استطلاعية لسجن عكاشة بالدار البيضاء، مهمة استطلاعية مؤقتة لمجموعة تهيئة العمران، مهمة استطلاعية لمعمل رونو بمدينة طنجة…
- أما على مستوى تقييم السياسات العمومية:
فإن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان لم يكن كافيا لتوضيح كيفية تطبيق البرلمان لعملية تقييم السياسات العمومية، وتفسير بعض جوانب الغموض الذي شمل بعض نصوصه لدرجة أصبحت معه عملية التقييم صعبة المنال من ناحية التفعيل والإعمال، لذلك تطلب الأمر إحداث ما سمي بالإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية من طرف مجلس النواب الذي صدر في أواخر دورة ابريل 2016، حيث تطرق إلى الإطار المفاهيمي لعملية التقييم وكذلك كيفية ممارسة البرلمان لكل اشكال التقييم مستعينا بالتجارب المقارنة، وقد أنجز مجلسي البرلمان مهمة التقييم في ظروف صعبة وضمن أجال قصيرة بسبب عدم استيعاب النواب لفلسفة التقييم كما يجب، إضافة إلى عدم توفر بيانات خاصة لدى الإدارات المركزية والمحلية وغياب مسوحات ميدانية ونظام معلوماتي ملائم، وعليه فإن هذا التقييم ليس نموذجا يحتدا به لعمليات تقييم السياسات العمومية التي على البرلمان انجازها مستقبلا، والتي يجب أن تجرى في ظروف أكثر ملائمة للإطار المرجعي المعتمد وأكثر احتراما للمعايير الدولية.
أما الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية فهناك عدة إشكالات لا تعد ولا تحصى وأبرزها ما يتعلق بتكوين أعضاء اللجان والسلوك البرلماني، ذلك أن الأول غالبا ما يخضع لاعتبارات شخصية و حزبية في الانتقاء، ويخضع في أحيان كثيرة إلى منطق إرضاء الخواطر عندما يتعلق الأمر بالخريطة التوزيعية للأدوار بين مكونات الأغلبية والمعارضة، وهو ما يؤثر سلبا على العمل البرلماني ويؤدي إلى نقص في الأطر المتخصصة والمؤهلة والموضوعة رهن إشارته، والتي تتطلب توفر حد اكبر من منهجية العمل والكفاءة والخبرة الضرورية لانجاز المهام المنوطة به، في مقابل ذلك نجد أن الحكومة تتوفر على إمكانيات اكبر وأطر مؤهلة لانجاز دراسات حول النصوص القانونية، أما الثاني فهو مرتبط بافتقاد السلوك البرلماني الذي يتجسد من خلال انعدام حلقة للتواصل بين عضو البرلمان والرأي العام وعدم اطلاع وسائل الإعلام على أعمال اللجان والخوض في جل نقاشاتها المستفيضة وتقديم مالها وما عليها، وقيامها بدور الكشف عن سلوك أعضاء البرلمان وأدائهم وفق ماهو كائن وما يجب أن يكون.
لقد قام دستور 2011 على تقوية دور البرلمان وخصوصا مجلس النواب من أجل جعله المعبر الحقيقي عن إرادة الأمة، ورغم هذا التوجه فإن مؤسسة البرلمان عموما تضل مشرع استثنائي أمام الحكومة التي يخول لها الدستور اختصاصات صريحة.
وكذلك أثبتت الممارسة السياسية دورها المهيمن على التشريع، إلا أن هذا الأمر لا يبخس من عمل البرلمان ولا يفرغ الدور الريادي للبرلمان في عدة مجالات وخصوصا في مجال التشريع ومجال المراقبة، وإذا كانت المستجدات الدستورية والقانونية ضرورية ومهمة في تاطير العمل البرلماني، فإنها تحتاج إلى نخب برلمانية أكثر جرأة من اجل الانتقال بمنطوق فصول الدستور من دفتي الوثيقة الدستورية إلى واقع سياسي أكثر دينامية وفعالية.